Droit/DSP/tic2024/Azi Zahira
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
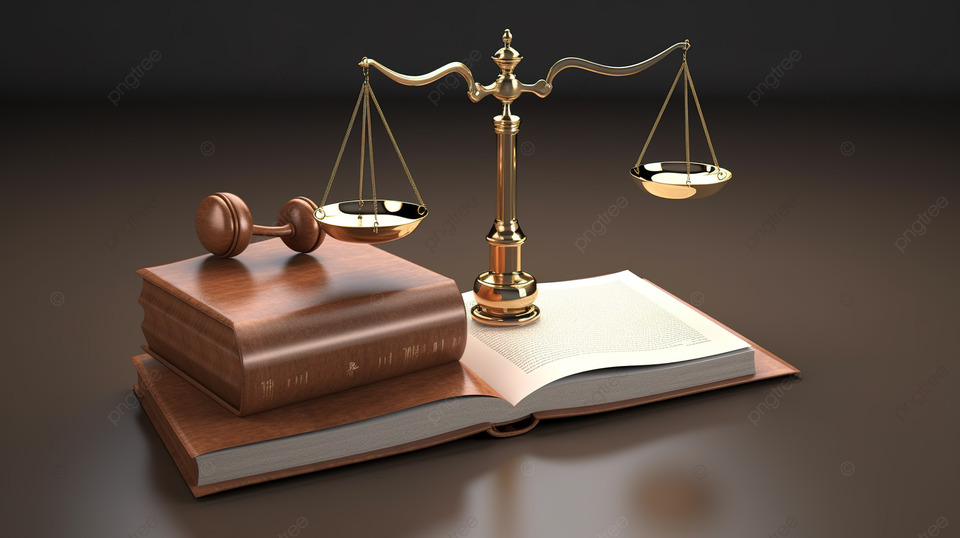
إن مقياس مدخل العلوم القانونية يمكن طالب السنة الأولى من الولوج إلى عالم تخصصه الجديد والتعرف على مفرداته الهامة، وهي تساعده على التعرف بعلم القانون من خلال القواعد العامة التي تحكم الفروع المختلفة.
المقياس: المدخل للعلوم القانونية
الفئة المستهدفة: موجه لطلبة السنة أولى حقوق نظام LMD
الرصيد: 07 المعامل: 02
الحجم الساعي: ساعة ونصف في الاسبوع.
-
الاستاذة: عزي زهيرة
التوقيت: الاثنين 08:00 إلى 12:30
قاعات التدريس: Z4. Z5 . Z6
الموسم الجامعي: 2023- 2024
التواصل يكون عبر الايميل: azi.zahira@univ-msila.dz
أيام التواجد في الكلية: الاثنين والأربعاء من 8:00 -12:30
-
-
حزمة سكورم
-
الملف
-
-
-
منتدى

-
المحادثة

-
-

اهداف خاصة بالتذكر
ان يتذكر الطالب جميع المفاهيم والتعاريف والمصطلحات التي تلقاها في المحور السابق والتي لها علاقة بعناصر هذا المحور مثل تعريف القانون، تعريف القاعدة القانونية خصائص القاعدة القانونية....
اهداف خاصة بالفهم
ان يفهم الطالب الأفكار التي يشمل عليها الدرس من تعريفات للقانون العام والقانون الخاص، المعيار الأساسي المعتمد للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص وأيضا يتعرف على كل فروع القانون سواء الخاص منها والعام. وتعريف القاعد الامرة والقاعدة المكملة ومعايير التمييز بينهما.
اهداف خاصة بالتحليل
ان يستطيع الطالب ان يميز بين القانون العام والقانون الخاص وان يميز بين القاعدة الامرة والقاعدة المكملة باعتماده على المعايير المعتمدة.
اهداف خاصة بالتطبيق
يساعد الطالب التعرف على تقسيمات القانون ومعرفة الفروق بينها وكيفية تطبيق وتوظيف هذه المعارف التي تحصل عليها في كل مجالات العلمية.
اهداف خاصة بالتقييم
تقييم وتصنيف ما اكتسبه من معارف واستعمال المعارف المتعلقة بالدرس في بحوثه الجامعية وتوظيف المعرفة المكتسبة بأشكال جيدة في مختلف المجالات العلمية.
-

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤهله لدراسة المقياس وكل محاوره ودراسته للمحور الاول وفهم كل جزيئاته تمكنه من دراسة وفهم هذا المحور ويساعده التفكير المنطقي على استعابه وتحصيله.
-
-
الملف
-
-
ان المدخل الى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية وهذ يعني ابتداء ان المدخل الى علم القانون ليس مرتبطا بفرع من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني.
إن مقياس مدخل العلوم القانونية يمكن طالب السنة الأولى من الولوج إلى عالم تخصصه الجديد والتعرف على مفرداته الهامة، وهي تساعده على التعرف بعلم القانون من خلال القواعد العامة التي تحكم الفروع المختلفة.
وتتخذ المادة عدة تسميات في اللفظ دون المفهوم فتسمى بأصول القانون أو المبادئ العامة للقانون أو علم القانون أو المدخل لدراسة القانون وفي المنهج الرسمي يسمى مدخل العلوم القانونية. ومهما اختلفت التسميات فإن موضوعها ومفهومها يبقى واحد ويمكن تحديده بأنه '' علم يتخذ من القانون موضوعا له فيبحث فيما يحكمه من مبادئ عامة ونظريات مشتركة بين
الأمم''.
ان النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما يقوم على أسس ومبادئ ونظريات عامة تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة لها مدلولات ثابتة لا تتغير وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل للعلوم القانونية وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الاساسيتان وهما النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وستقتصر دراستنا في هذ السداسي الأول على النظرية العامة للقانون اما قسم الثاني المتمثل في النظرية العامة الحق سيكون محل دراسة في السداسي الثاني.
وعليه تستوجب دراسة النظرية العامة للقانون تقسيم موضوع الدراسة إلى:
أولا: التعريف بالقانون والخصائص المميزة لقواعده.
ثانيا: علاقة القاعدة القانونية بغيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى وصل القانون بالعلوم الاجتماعية الأخرى.
ثالثا: التقسيمات المختلفة للقانون والقاعدة القانونية.
رابعا: مصادر القانون.
خامسا: تطبيق القانون.
-
الملف
-
-
يقسم القانون من حيث طبيعة العلاقة التي ينظمها إلى قانون عام وقانون خاص سنعالج مضمون هذا القسم في عنصريين نخصص الأول لتقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص ونكرس الثاني لفروع كل من هذين القسميين.
المطلب الأول: تقسيم القانون إلى عام وخاص
ينقسم القانون من حيث طبيعة الروابط التي ينظمها الى قانون عام وخاص وهناك من يطلق على هذا التصنيف من حيث أطراف العلاقة وهذا تقسيم تقليدي يرجع تاريخه إلى القانون الروماني، وقد كان الهدف منه هو جعل الحاكم يتميز عن المحكومين، لكن هذه التفرقة زالت على اثر انهيار الدولة الرومانية وانتقل هذا التقسيم الى الفقه اللاتيني الحديث حيث لاتزال التفرقة بين القانون العام والخاص قائمة مسلمة بها الى يومنا هذا وفي دراستنا هذه سوف نتعرف عن معايير التفرقة بينهما واهمية هذا التقسيم [1]
الفرع الاول: معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص
رغم ان هذا التقسيم مسلم به في الفقه اللاتيني الحديث إلا أنه حدث اختلاف بين الفقهاء في تحديد معياره وكانت نتيجته تعدد في المعايير المقترحة للتفرقة وسنتطرق إلى أهمها:
اولا: معيار الأشخاص أطراف العلاقة القانونية
إن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص حسب هذا المعيار تقوم على أساس الأشخاص أطراف العلاقة القانونية، فإذا تعلق الأمر بعلاقة الدولة أو أحد فروعها بالأفراد أو بدولة أخرى، نكون أمام القانون العام بينما يخلص للقانون الخاص تلك العلاقات التي يكون أطرافها من الأفراد.[2]
وقد وجه نقدا لهذ المعيار على أساس ان مباشرة الدولة لنشاطها مع الأفراد لا يكون على نفس قدم المساواة فقد تدخل بوصفها مجرد شخص معنوي عادي كباقي الأشخاص المعنوية الخاصة دون أن تمثل السلطة العامة (تصرف في الأملاك الخاصة) وفي هذه الحالة يخضع نشاطها للقانون الخاص وبالتالي فلا حاجة لتميز هذه العلاقة بحجة أن الدولة طرفا فيها.
وقد تتدخل الدولة في علاقة قانونية باعتبارها صاحبة سيادة فتكون في مركز أقوى من الطرف الآخر والقانون العام هو الحاكم لهذه العلاقة، ومنه يمكن القول ان اعتماد هذا المعيار ليس دائما صحيحا[3].
ثانيا: معيار طبيعة المصلحة:
يذهب البعض الى ان المصلحة العامة هي معيار التفرقة بين القانون العام والخاص ويبررون ذلك بانه اذا كان صحيحا ان جميع قواعد القانون تهدف الى تحقيق المصلحة العامة فان القانون العام وحده هو الذي يحقق المصلحة العامة المباشرة اما القوانين الأخرى فتسعى الى تحقيق المصلحة الخاصة ولكن يمكن الرد على هذا الراي بانه تحديد التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فقانون الاسرة قانون خاص ولا يمكن القول بانه ينضم مصلحة خاصة فقط فتنظيم الاسرة يحقق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى وبالتالي يحقق ايضا مصلحة عامة.[4]
ثالثا: معيار طبيعة القواعد
إن وجود اختلاف بين القواعد القانونية من حيث طبيعتها مبرر كاف لأعمال مبدأ تقسيم القانون إلى عام وخاص حيث هناك قواعد قانونية آمرة وجزء لا يتجزأ من النظام العام وهي قواعد مدمجة في إطار القانون العام وبالمقابل هناك قواعد قانونية تكتفي بتنظيم مصالح خاصة بين الأفراد العاديين البعض منها قواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، وتدرج هذه القواعد ضمن نطاق القانون الخاص وتأسيسا على ذلك فطبيعة القاعدة القانونية هي التي تفرض وجود مثل هذا التقسيم[5]، وجه إلى هذا المعيار أيضا نقدا باعتبار أنه معيار غير دقيق وغير حاسم فيوجد في قواعد القانون الخاص قواعد آمرة الى جانب القواقد المكملة كقواعد الميراث مثلا .[6]
رابعا: معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية
يقوم هذ المعيار للتفريق بين القانون العام والقانون الخاص على أساس اطراف العلاقة من جهة، وطبيعة العلاقة من جهة أخرى فوفقا لهذا المعيار فان القانون العام هو الذي ينظم علاقة الدولة بغيرها عندما تتعامل مع هذا الغير بوصفها سلطة تمارس سيادة ، وبذلك فان القانون العام هو مجموعة القواعد التي تحكم عمل سلطات الدولة وتوزيع الوظائف فيما بينها وتنظم وتسير إدارة المرافق العامة، وتحدد علاقتها بالاشخاص الاعتبارية الدولية، ويعد هذا المعيار من اقرب المعايير الى الواقع العملي[7].
وبذلك اصبح معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يقوم على أساس الصفة التي تدخل بها الدولة او احد فروعها طرفا في العلاقة القانونية وليس مجرد وجودها كطرف فيها.
من هنا يمكننا
تعريف القانون العام: بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
تعريف القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض الآخر، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص لا باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.[8]
وبذلك فالقانون العام يوصف بأنه قانون السيطرة أو الخضوع أما القانون الخاص فهو قانون المساواة أو التوازن ويبقى معيار صفة الأشخاص المعيار الأرجح رغم ما وجه إليه من نقد في أن الأفراد حينما يمارسون حرياتهم أو يشاركون في تكوين السلطة عن طريق الانتخابات، إنما تحكمهم قواعد القانون العام مع أنهم لا يقومون من الواقع باستعمال حقيقي لحق السيادة.[9]
الفرع الثاني: أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص
إن تقسيم القانون إلى عام وخاص نجم عنه اختلافات يمكن تلخيصها في:
اولا: في مجال الامتيازات
في سبيل تحقيق اغراض القانون العام فان هذ القانون يعطي الهيئات العامة في الدولة سلطات لا يوفرها القانون الخاص للفراد كسلطات الاستملاك ونزع الملكية للمنفعة العامة والاستلاء المؤقت والى غير ذلك.[10]
ثانيا: في مجال العقود
تتميز العقود الإدارية التي تبرمها الدولة باعتبارها صاحبة سيادة بأنها لا تقف موقف المساواة مع العقود المبرمة من طرف الأشخاص العاديين بل هي في مركز ممتاز يسمح لها بتوقيع جزاءات على المتعاقد معها في حالة الاخلال بالشروط فيثبت لها الحق في إلغاء العقد أو تعديل شروطه مع تعويض المتعاقد الآخر.[11]
ثالثا: في مجال الأموال العامة: يفرد القانون للأموال العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المخصصة للنفع العام حماية خاصة تتمثل في عدم جواز التصرف فيها أو حجزها أو تملكها بالحيازة.[12]
رابعا: في مجال طبيعة القواعد القانونية
على اعتبار ان القانون العام يهدف أساس الى تحقيق المصلحة العامة وحمايتها فان قواعده كلها امرة لا يجوز لاي شخص الخروج عليها او الاتفاق على مخالفتها ، بينما في القانون الخاص الى جانب القواعد الامرة هناك قواعد مكملة يجوز للأفراد باتفاقهم الخروج عنها لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصة.[13]
خامسا في مجال الاختصاص القضائي: ان المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الإداري بينما الدعاوى الأخرى يكون النظر فيها من اختصاص القضاء العادي[14]
المطلب الثاني: فروع القانون العام وفروع القانون الخاص
لكل من القانونين فروع فالقانون العام يتفرع عنه القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي وهذه تخص القانون العام الداخلي وهناك القانون العام الخارجي أما القانون الخاص فينبثق منه القانون المدني، القانون التجاري، القانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل والقانون الدولي الخاص.
الفرع الأول: فروع القانون العام
وينقسم الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي
اولا: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)
القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام) هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي (دول، منظمات دولية، هيئات دولية) في زمن السلم وفي زمن الحرب، فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة وحقوقها باعتبارها صاحبة سيادة[15].
وتتمثل مصادره في:
1-المعاهدات الدولية 2-العرف الدول 3-المبادئ القانونية العامة
هناك من يعتبر ان قواعد القانون الدولي العام لا تعد قوانين دولية لعدم وجود سلطة تشريعية عامة تضع القواعد وتراقبها, وتتولى توقيع الجزاء على من يخالفيها لكن يمكن الرد على هذا القول بانه وان لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي الا ان مصادر القانون العرف أيضا والقانون الدولي مصادره العرف الدولي والمعاهدات الدولية ، اما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فان ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه، ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار واستعمال القوة المسلحة.[16]
ثانيا: القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها، حين تعمل بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة، وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة، او فيما بين هذه الفروع [17]
والقانون العام الداخلي يشمل على فروع مختلفة هي:
1-: القانون الدستوري
يعد القانون الأساسي للدولة وهو اعلى درجة في النظام القانوني ويظم مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة فيها والهيئات التي تمارسها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، كما يختص ببيان حقوق وواجبات الأفراد وحرياتهم كالحق في التقاضي والحق في الانتخاب وحق التعليم وحرية الرأي وواجب الخدمة الوطنية[18].
ان القانون الدستوري وهو يتناول هذه الموضوعات يقتصر فيها على أمهات المسائل، تاركا التفاصيل إلى بقية القوانين وهو يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة.
2_ القانون الإداري: هو احد فروع القانون العام الداخلي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة او هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة من حيث الضبط الإداري وكيفية قيامها بأداء وظيفتها كسلطة إدارية من إدارة المرافق العامة واستغلال الأموال العامة وكيفية مراقبة الافراد لعمالها، والجهة المختصة بذلك كما يشمل تنظيم الجهاز الاداري في الدولة والعلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية في الأقاليم، والعلاقة بين الإدارة وموظفيها، وتنظيم أموال الدولة ، كالفصل في المنازعات التي تقوم بين الإدارة والافراد[19]
3- القانون المالي: هو الذي ينظم مالية الدولة من حيث تحديد وجه المصروفات المختلفة وبيان مصادر الإيرادات وكيفية تحصيلها وإعداد الميزانية وتنفيذها وأسس الرقابة على ذلك.[20]
4- القانون الجنائي: ويسمى بالقانون الجزائي وهو مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم المعاقب عليها قانونا مع العقوبة المقررة لكل منها وكذلك الإجراءات التي تتبع لتعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه إذا ثبت إجرامه.
والقانون الجنائي يشكل طائفتين من القواعد كل طائفة تكون فرعا لهذا القانون:
قواعد موضوعية ويطلق عليها قانون العقوبات
وهي التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها وتسمى قانون العقوبات. وهو مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات التي توقع على مرتكبها وتبين شروط المسؤولية الجزائية وظروف الإعفاء أو التخفيف منها.[1]
وفيها قسمان الأول هو القسم العام والذي ويشمل على تحديد معنى الجريمة واركانها ويحدد القواعد العامة للمسؤولية الجنائية مبينا الجريمة وتحديد من هم المسؤولون عن وقوعها، ويحدد أسباب الإباحة والإعفاء من العقوبة ويتناول الظروف المخففة والمشددة. اما الثاني هو القسم الخاص والذي فيتضمن القواعد التي تنظم كل جريمة على حدى مبينا أركانها وصورها المختلفة التي توقع على مرتكبيها ويقسم الجرائم إلى جرائم أشخاص وجرائم أموال وجرائم واقعة على امن الدولة ويحدد العقوبة المفروضة على مرتكبيها[2].
وقد صدر قانون العقوبات الجزائري بالأمر رقم 156 المؤرخ في 08 جوان 1966، ومن أهم المبادئ المقررة فيه أن ''لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص''[3].
قواعد شكلية أو إجرائية ويطلق عليها قانون الإجراءات الجزائية:
ويتضمن القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في حال حصول الجريمة من حيث التحقيق مع المتهم والجهة التي تقوم به، وكذلك إجراءات المحاكمة وتحديد المحكمة المختصة وطرق الطعن بالأحكام وجهة تنفيذ العقوبة.[4]
وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بالأمر رقم 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 في نفس اليوم الذي صدر فيه قانون العقوبات.
وهناك من يرى أن القانون الجنائي قانون مختلط فمن جهة يدخل في القانون العام لأنه يقوم على فكرة الدفاع عن المجتمع ومن جهة أخرى فقواعده تعاقب على جرائم تقع على الأفراد أنفسهم وتضر بحقوقهم وبمصالحهم الخاصة وأنه في بعض الجرائم يستطيع المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية وبالتالي يدخل في إطار القانون الخاص ولكن هذا الرأي منتقد لأن الجريمة تعد اعتداء على المجتمع واخلالا خطيرا بالأمن والطمأنينة رغم أنها اعتداء على حقوق الأفراد وهذا الاعتبار هو الذي يبرر سلطة الدولة في العقاب وتمارسه بوصفها صاحبة سلطة وسيادة.
الفرع الثاني: فروع القانون الخاص
القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلوك العادي للأشخاص العاديين طبيعيين كانوا أم معنويين كشخص عادي اتجاه الغير.
ويتفرع القانون الخاص الى عدة فروع نذكر منها:
القانون المدني–القانون التجاري، القانون البحري، القانون الجوي، قانون العمل، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون الدولي الخاص.
أولا: القانون المدني:
هو اهم فروع القانون الخاص وأكثرها تنظيما وتفصيلا واستعابا للقواعد القانونية وهو ما جعل المختصين في القانون يسمونه الشريعة العامة او القانون الام لمجموع فروع القانون الخاص الأخرى ، وتكمن أهمية الانتشار الواسع للمعاملات المدنية التي تتطلب ضبطها بقواعد قانونية ذات طبيعة مدنية فلا يمكن للفرد ان يتجنب الدخول في معاملات مدنية فقد يبيع او يؤجر او يقرض او يرهن منقولا وما الا ذلك من المعاملات المدنية التي يكون فيها الفرد طرفا فيها وحماية لمصالحه وجب ان يكون هناك قانون يضبط تلك المعاملات ويحدد الحقوق وواجبات كل طرف في تلك المعاملة "عقد البيع مثلا".
وقد صدر القانون المدني في الجزائر لأول مرة سنة 1975 وهو يتناول عدة مواضيع أهمها تنازع القوانين، الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، العقود، الحقوق الشخصية، الحقوق العينية، الاصلية والتبعية[5].
ثانيا: القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع، والشركات التجارية بأنواعها.[6]
وأن الحكمة من استقلال القانون التجاري عن القانون المدني تتمثل في تفادي عدم ملائمة القواعد المدنية لمتطلبات التجارة خاصة فيما يتعلق بالسرعة والائتمان
وقد صدر القانون التجارية بمقتضى الأمر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم[7] .
ورغم خصوصية القانون التجاري واستقلاليته عن القانون المدني، فإن ذلك لا يمنع من القول أن القانون المدني يظل هو الأصل لفروع القانون الخاص كافة ويتوجب الرجوع إليه في حالة عدم وجود نص في الفروع عن معالجة أو تنظيم مسألة معينة.
ثالثا: القانون البحري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بصدد الملاحة البحرية وترتكز أساسا حول السفينة من حيث بيعها والتأمين عليها ورهنها وحجزها، كما ينظم العقود المتعلقة بالنشاط البحري مثلا علاقة الملاحين بمالك السفينة وبين مسؤولية كل منهما وعقد النقل البحري للبضائع والأشخاص وكذلك مسائل التأمين البحري وهو من الفروع التابعة للقانون التجاري لذا يطلق عليه قانون التجارة البحري، على أساس أن الأعمال التي ينظمها تعتبر أعمالا تجارية ولكنه استقل نظرا لضخامة وسيلة التجارة البحرية وهي السفينة وما تتعرض له من مخاطر ذات طبيعة خاصة، كما أن القانون البحري يستمد كثيرا من قواعده من الاتفاقيات الدولية.[8]
وقد صدر القانون البحري الجزائري بالأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23/10/1976 المعدل والمتمم[9]، وقد عرف السفينة في المادة 13، ونصت المادة 65 من القانون البحري عن شروط اكتساب السفينة للجنسية الجزائرية حيث قواعد القانون البحري تتميز بالطابع التقني.
رابعا: القانون الجوي
هو قانون حديث النشأة ويعرف بانه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية وقد صدر بموجب القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27/06/1998 والذي يحدد القواعد العامة للطيران المدني.[10]
خامسا: قانون العمل
يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العامل التابع ورب العمل المتبوع الذي يكون له توجيه العامل وحق الإشراف عليه مقابل الأجر الذي يدفعه لذلك العامل[11] وهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه.[12]
وتسمى علاقة العامل برب العمل بالعلاقة التبعية وقد صدرت في الجزائر عدة تشريعات عمالية منها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
ويرى البعض أن قانون العمل من فروع القانون العام نظرا لتدخل الدولة في الإشراف على علاقات العمل وتوقيع جزاءات جنائية على مخالفة قواعده[13] فجل قواعده آمرة.
وهناك من اعتبر قانون العمل قانونا مختلطا لأنه من جهة ينظم العلاقة الخاصة التبعية ما بين رب العمل والعامل وبهذا فهو فرع من فروع القانون الخاص هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فقواعده تتضمن قواعد تدخل في صميم القانون العام كالقواعد الخاصة بتفتيش أماكن العمل ونظام التحكيم في منازعات العمل.[14]
إلا أن الرأي الراجح هو أن قانون العمل يدخل ضمن فروع القانون الخاص نظرا لطبيعة الموضوعات الإنسانية الي تنظمها قواعده والتي تدور حول تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل، وهذه العلاقة لا شأن لها بحق السيادة في الدولة إذا نظرنا إلى معيار صفة الأشخاص.
سادسا: قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
صدر قانون الإجراءات المدنية بمقتضى الأمر 66-154 المؤرخ في 08 جوان 1966 يحكم قواعد التنظيم الإجرائي بوجه عام لغاية أن تم الغائه وحل محله قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أدخل على هذه القواعد بعض التغيرات الجوهرية في الشكل والمضمون، وبالأخص نقول من الناحية التقنية وذلك بعدد من الخصوصيات بأن في مقدمتها كونه أكبر حجما منه إذ يتشكل من 1065 مادة بينما قانون الإجراءات المدنية الملغي فكانت 479 مادة وكذلك الاختلاف في استحداث أحكام كتلك التي نصت عليها م 21 من ق إ م إ المتعلقة بطريقة تقديم المستندات بإيداعها لدى كتابة الضبط وتبادلها بين الأطراف بالإضافة إلى صياغات جديدة لأحكام قديمة مثل المادة 14 من ق إ- م والإدارية المقابلة للمادة 12 من القانون الملغي ومن تخليه عن أحكام لم تعد تساير مستوى تطور المجتمع والأفكار السائدة فيه كإلغاء المواد المتعلقة بالإكراه البدني المواد من 407 إلى 412 ق إ-م.
وأيضا أن القانون الجديد سمي بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقد تضمن مبادئ عامة التي توحي بما سيكون عليه موصوفة الجرأة والتجديد وهذا من أجل التكيف مع الأزمنة، وتكريسه لمبدأ المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة أمام القانون والوجاهية والتقاضي على درجتين وتسبيب الأحكام القضائية والنص في الدعاوي ضمن آجال معقولة[15].
سابعا: القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تعالج الحالات التي تتضمن عنصر أجنبيا، والمقصود بالعلاقة الدولية الخاصة بأنها تخرج من النطاق الوطني إلى المجال الدولي، غير أن الطابع الدولي لا يهم الدولة بوصفها صاحب سيادة بل يهم الأفراد العاديين طبيعيين كانوا أم معنويين في علاقاتهم الخاصة فيما بينهم أي بين الشخص المواطن والشخص الأجنبي[16]
وهو أيضا ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعة للدولة وأحكام الموطن ومركز الأجانب فيها، ويبين الحلول الواجبة الاتباع في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين.[17]
[1]يحي قاسم علي، المرجع السابق، ص 64.
[2] الشاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق،ص 84-85.
[3]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 87.
[4]يحي قاسم علي، المرجع السابق، ص 65.
[5] ليلي بن حليمة، المرجع السابق،ص 10.
[6]شاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق، ص 88.
[7]الأمر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ج.ر، العدد ،
[8]محمد قجالي، المرجع السابق، ص 50.
[9]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 95.
[10]الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن القانون البحري، المعدل بالقانون رقم 98-05 المؤرخ في 25/06/1998، ج ر، عدد 47 بتاريخ 27 يونيو 1998.
[11]إسحاق إبراهيم منصر، المرجع السابق، ص 69.
[12]شاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق، ص 89.
[13]محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 31.
[14]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 98.
[15]عبد المجيد زعلاني، المرجع السابق، ص 162.
[16]عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 151.
[17]إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص 70.
[1]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،ص65-66.
[2] محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،ص، 66.
[3]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 70.
[4] محمدي فريدة، المرجع السابق، ص32.
[5]عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 133.
[6]محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 24.
[7]،ص95_96. الشاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق
[8]عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص 22.
[9]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 74.
[10] عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص 23.
[11]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 74.
[12]عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص 23.
[13] الشاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق،ص 97.
[14] الشاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق،ص 97.
[15] محمدي فريدة، المرجع السابق،ص33
[16] محمدي فريدة ،المرجع السابق، ص 33. .
[18] محمدي فريدة ،المرجع السابق، ص 30 .
[19] ليلى بن حليمة ، محاضرات في مدخل للعلوم القانونية،ص9.
[20]مولود ديدات، المرجع السابق، ص 11.
-
الاختيار
-
الاختيار
-
-
يمكن تصنيف القاعدة القانونية من حيث قوة الالزام أي من حيث سلطة الأفراد في الخضوع لها إلى قواعد آمرة (باتة – الناهية) وقواعد مكملة (مفسرة) سنتعرف فيما يلي على كل من القواعد الامرة والقواعد المكملة
المطلب الأول: القواعد الآمرة
القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على عكسها أو على استبعاد حكمها فالقاعدة الآمرة هي قاعدة مطلقة من حيث تطبيقها وتنعدم في مواجهتها حرية الأفراد سواء كان فيما يتعلق بتعديلها أو تغيير حكمها أو استبعادها[1].
فهي القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهى عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعتد به ويعد باطلا، ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حرية الأفراد وهي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة.[2]
والقواعد الآمرة (الناهية) تتميز بأنه لا يجوز الاتفاق على عكسها فلا يملك الأفراد مخالفتها إيجابا أو سلبا فهي ملزمة في الحالتين ووجه الالزام واضح وهو الجزاء المقرر الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على السواء[3] ويترتب عن ذلك انعدام تام لإرادة الأطراف اتجاهها وخضوع مطلق لأحكامها، وهي مقررة للمصلحة العامة ولها ارتباط وثيق بكيان المجتمع ومبادئه ونظامه العام وآدابه العامة[4].
وخلاصة القول أن القاعدة الآمرة هي تلك القاعدة التي تأمر بسلوك معين أو تنهي عن سلوك معين تحت طائلة بطلان السلوك المخالف[5] حيث أن العلاقة بين القاعدة وإرادة الأفراد المخاطبين بها هي علاقة الخضوع الكامل وكل اتفاق يخالفها يكون باطلا بطلانا مطلقا.
ومن امثلتها:
_القواعد التي تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها، والعلاقات فيما بين السلطات العامة.
_قواعد تقنين العقوبات التي تبين الجرائم ونحدد العقوبات المقررة لها.
_القواعد التي تنهي عن التعامل في تركة الانسان
المطلب الثاني: القواعد المكملة (المفسرة).
هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على تطبيق ما يخالف حكمها، لأنها لا تتصل بالمصلحة العامة للجماعة، بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد ولهم واسع الإرادة أمامها إذا يمكنهم العمل بمقتضى إرادتهم الخاصة واستبعاد هذه القواعد ضمنيا دون الإشارة على ضرورة استبعادها، غير أنه إذا تم ترك بعض المسائل دون تنظيم، فالقواعد المكلمة الموضوعة من طرف المشرع هي التي تطبق.[6]
هنا تستعيد الإرادة مكانتها فيطلق على هذه القاعدة اسم
القاعدة المفسرة أو المقررة ولكن المصطلح الأفضل هو المكملة لأنها تكمل الفراغ في حالة عدم الاتفاق على حكم معين أو إذا كان الاتفاق ولكن ناقص.
ومن أمثلتها:
- القاعدة التي تقرر أن الثمن يكون مستحق الوفاء في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، م 387 و388 من القانون المدني.
- القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة المكان المستأجر ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك م 479 من القانون المدني.
إن القواعد المكملة إلزامها نسبي، فإذا لم يتفق الأفراد على عكسها أصبحت قاعدة آمرة، حيث أن للأفراد مطلق الحرية في مخالفتها أو الاتفاق على عكسها ولكن إذا سكتوا عن موضوعها أو أغفلوه تكون تلك القواعد ملزمة لهم.[7]
المطلب الثالث: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
من اجل التفرقة بين القواعد الامرة والقواعد المكملة يمكن الاعتماد على معياريين
أولا: معيار الصياغة أو المعيار اللفظي (النص):
بالرجوع الى نص القاعدة القانونية يتضح من صياغتها ما يدل على ان النص امر او يتضمن قاعدة مكملة فتعد القاعدة امرة اذ نصت على عدم جواز الاتفاق على مخافتها وتعتمد صيغ عديدة ، وتعد القاعدة مكملة اذا نصت على جواز الاتفاق على مخالفتها ويظهر ذلك أيضا من خلال صياغتها [8] .والجدول الاتي يبين بعض الصيغ التي على أساسها يمكن التفريق بين القاعدة الامرة والقاعدة المكملة.
قاعدة امرة
قاعدة مكملة
-لايجوز.....
-ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك
- تقع تحت طائلة البطلان......
-يقع باطلا..........
-...........مالم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك
-.........مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
-يحق لك.........
-......كان له الحق
-لا يجوز......
-يمكن ل.....
أولا: المعيار الموضوعي او (المعنوي):في حالة عجز صياغة النص من الإفصاح عن طبيعة القاعدة القانونية فيتبين في مثل هذه الحالة الرجوع إلى مضمون النص والاستئناس بمعناه، فإذا تعلق المضمون بالمصالح الأساسية للمجتمع وبمقوماته أي بالنظام العام والآداب في المجتمع كانت القاعدة آمرة[9] وإذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد كانت القاعدة مكملة، وبذلك يعد معيار النظام العام والآداب العامة هو المعيار الموضوعي للتفرقة بين القواعد الامرة والقواعد المكملة لكن السؤال المطروح ماذا نقصد بالنظام العام والآداب العامة؟
1- المقصود بالنظام العام
ويقصد بالنظام العام أيضا مجموعة المصالح الجوهرية للمجتمع أو مجموعة الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع بحيث لا يتصور قيام هذا البنيان عند تخلفها سواء كانت أسس اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية كالأسس التي يقوم عليها نظام الدولة او الأسس التي تقوم عليها الأسرة او الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والأسس الخلقية التي يقرها المجتمع في زمن معين للحفاظ على القيم التي يؤمن بها[10].
2-: المقصود بالآداب العامة
هي تلك القواعد الخلقية الأساسية والضرورية لقيام وبقاء المجتمع سليما من الانحلال فهي بذلك تعد القدرة من المبادئ التي تنبع من التقاليد والمعتقدات الدينية والأخلاقي في المجتمع، والتي يتكون منها الحد الأدنى للقيم والاخلاقيات التي يعد الخروج عليها انحرافا وتحللا يدينه المجتمع. اي ان الآداب العامة هي التعبير الخلقي عن فكرة النظام العام.
وهي وتتأثر بعوامل مختلفة كالدين والتقاليد والفلسفة السائدة في المجتمع. بالتالي فهي تتغير من زمن الى اخر ومن مكان الى اخر وتختلف باختلاف الشعوب ودياناتهم وثقافاتهم[11].
ومن أمثلتها القاعدة التي تنهى عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة فهي قاعدة آمرة لا تجيز للشخص أن يتعامل في المال على أساس أنه سيرثه في المستقبل فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث، وايضا نص م 145 ونص م 402 ونص المادة 403 من ق.م العقوبات التي تنظم الجرائم والعقوبات المقررة لها.
[1]عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص 32.
[2]شاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق، ص 99.
[3]إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط8، الجزائر، 2005، ص 82.
[4]عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 220.
[5]عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 220.
[6]محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 111.
[7]إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص 84.
[8] شاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق،ص،103.
[9]عباس الصراف، جورج حزيون، المرجع السابق، ص 35.
[10] عبد المجيد زعلاني، المرجع السابق،ص39.
[11] الشاهر إسماعيل الشاهر، المرجع السابق،ص/110
-
الاختبار
-
-
1_إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق (وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2007،
2_محمدي فريدة، المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون)،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر ،1998.
3_يحيى قاسم علي، المدخل للعلوم القانونية،ط1، كومنتى للتوزيع، القاهرة،مصر، 1997.
4_شاهر إسماعيل الشاهر، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الأولى، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018 .
5_عباس الصراف، جرج حزبون، المدخل إلى علم القانون النظرية القانون، نظرية الحق، الطبعة الأولى، دار الثقافة، للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
6_عجة الجبلاني، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون بين التقليد والحداثة طبقا للمعايير الدولية المقررة لنظام LMD، ج1، برتي للنشر، الجزائر، 2008،
7_محمد سعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، الجزء 1، الطبعة1، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2018.
8_ليلى بن حليمة ، محاضرات في مقياس مدخل للعلوم القانونية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 2021-2022.9_سمير عبد السيد تناغو،النظرية العامة للقانون، منشاة المعارف،الاسكندرية،مصر، 1974.
